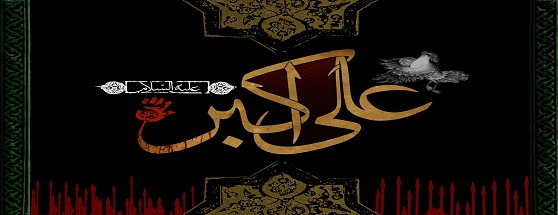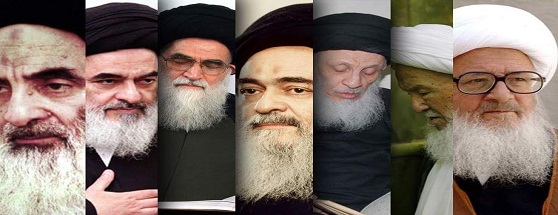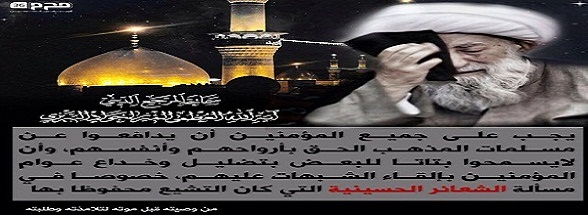شبهة :أن خمس ارباح المكاسب حكم ولائي وليس واجب في اصل التشريع القراني والا لتصدّى النبيُ إلى قبضه الأخماس بينما لم يُنْقَل هذا أبدًا، لا النبي ولا الإمام علي ولا الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا علي بن الحسين حتى عصر الكاظم إذن كيف يكون واجبًا في أصل القرآن ؟
![]()
#شبهة :
أن #خمس_ارباح_المكاسب حكم ولائي وليس واجب في اصل التشريع القراني والا لتصدّى النبيُ إلى قبضه الأخماس بينما لم يُنْقَل هذا أبدًا، لا النبي ولا الإمام علي ولا الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا علي بن الحسين حتى عصر الكاظم إذن كيف يكون واجبًا في أصل القرآن ؟
قلنا : توجد عدة تخريجات لحل الشبهة :
اولا : انّ الرسول لم يجمع الخمس؛ لأنّ الخمس مالٌ شخصي للنبيّ والأئمة من ذريته ، وليس مالاً عامّاً للأمّة، فمن غير المناسب له جمعه، على خلاف الزكاة
ثانيا : ما افاده السيّد المعظم الخوئي ان تشريع ارباح الارباح بعد وفاة النبي يعني ان الأحكام الشّرعيّة ما بلغت دفعة واحدة، وإنّما بلغت على نحو التدريج،النبي لم يبّلغ وجوبَ الصّلاة - وجوب الصّلاة الذي هو عمود الدّين - إلا في السّنة الثالثة من البعثة وهكذا أفعال الحج وحرمة الخمر لأنّ المصلحة كانت تقتضي التدرّج في تبليغ الأحكام، لو بلغ دفعة واحدة حصلت نتائج عكسية
ثالثا : أنّ النبيّ تعمّد عدم البيان خوفاً من أخذ الحكّام بعده هذا الخمس الذي هو لأهل البيت عليهم واستغلاله في مصالحهم الخاصة وتضييع الغاية من تشريعه شرعا .
رابعا : أنّ الخمس لم يكن واجب الجباية، واجب الدّفع لا واجب الجباية؟ فالزكاة فيها أمرين : يجب الدّفع، وتجب الجباية، لاحظ قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - يعني: أنت يجب عليك أن تتصدّى لقبض الزكوات ولقبض الصّدقات - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾
واما الخمس يجب على الناس دفعه لكن لا يجب على الحاكم الشّرعي أن ينصب لجبايته لاحظ قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، فيجب على الناس دفع الخمس لا أنّه يجب على النبي أنْ يتصدّى للجباية، لذلك النبي لم يتصدَ للجباية ولم يضع عمّالاً يجبون الأخماس، وكذلك الأئمة من بعده .
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
شبهة:ان مسالة العصمة هل اتفاق ام تطور وبمعنى اخر هل فهم العصمة كان واضحاً في القرون الثلاثة الأولى المعاصرة للائمة كان واضحاً كوضوح الصلاة ام مسالة اجتهادية؟

#شبهة:
ان مسالة #العصمة هل اتفاق ام تطور وبمعنى اخر هل فهم العصمة كان واضحاً في القرون الثلاثة الأولى المعاصرة للائمة كان واضحاً كوضوح الصلاة ام مسالة اجتهادية؟
قلنا : اعجب ان يلوح [ السائل] أن #نظرية_العصمة ضرورة علمائية وليست ضرورة مذهبية و القران هو اول من صرح بمسألة العصمة بمراحلها ودلائلها انظر قوله تعالى (( وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحى )) حتى وصفت الايات فؤاد الخاتم وعينه بانهما لايزيغان ولا يطغيان ولا يكذبان (( ما كذب الفؤاد مارأى مازاغ البصر وما طغى ))
ويفترض أن [ السائل] يؤمن بنظرية [ اسلام القران] التي طالما اطربنا بها في لياليه وأيامه وأن اية واحدة تعادل عنده《 شنط 》من فهم الروايات ؟؟ فما الذي جرى حتى صار فهم غير القران محل استدلال ؟؟
ان مراجعة مناظرات الامام الرضا (عليه السلام) في مجال العصمة عن الانبياء عامة والخاتم صلى الله عليه وعليهم اجمعين توضح أن نظرية العصمة ضرورة مذهبية [ انظرعيون اخبار الرضا ج٢ ص ١٧٠ _ ١٧٣]
ويشبه الاستدلال على نفي عصمة الأئمة عليهم السلام بعدم اعتقاد بعض أصحابهم عليهم السلام بها، إنكار خلافة أمير المؤمنين التي دلّ عليها الكتاب والسنة المتواترة وضرورة العقل بإنكار بعض الصحابة لها، مع ثبوت عدم حجية أقوال الصحابة وأفعالهم، فهذا الاستدلالات ونحوها في الحقيقة ترجع إلى رد الأدلة الصحيحة بأدلة غير صحيحة .
أن عصمة الأئمة عليهم السلام ثابتة بالخطاب القرآني وبقول المعصومين وضرورة العقل، وهي ادلة تامة صحيحة مذكورة في مظانه
ومما لا شك فيه أن هذه الأدلة هي التي يُرجع إليها في الاعتقاد بالعصمة أو عدمها، وهي كافية في الدلالة ووافية بالمطلوب، واما غيرها لا يصح الرجوع إليه نظير انكار البعض او قصور فهمه فتدبر ولا تغفل .
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
شبهة :بابا تكلم على التوحيد صير ملحد ماكو مشكلة بس عندنا الخطوط الحمراء في الحوزات لاتتكلم على الإمامة عجيب مولانا ؟

#شبهة :
بابا تكلم على التوحيد صير ملحد ماكو مشكلة بس عندنا الخطوط الحمراء في الحوزات لاتتكلم على الإمامة عجيب مولانا ؟
قلنا : ّ هذا الرجل لايكف عن الافتراء على حوزاتنا العلمية وعلمائها الكرام كما ادّعى ان التجاسر على #التوحيد وتبني الالحاد ليس خط احمر عندهم ويظهر نفسه المجدد ونقدر له هذا الجهد الذي كشف حقيقة نواياه الحاقدة ...
ونحن إذ نسجل اعتراضنا على تجاوزه نؤكد أحقية مسلك علماء الحوزة الكرام البررة ، هداة الأمّة وربّانيوها ، مسلك أئمتهم (عليهم السلام) في الدفاع والذبّ عن الدين الإسلامي الصافي ، عقيدة وشريعة ، فجاءت خطبهم ، ومناظراتهم ، وبياناتهم ، ودروسهم ، حتّى في أحلك ظروف الحبس والجبر والقهر ، جاءت أدعيتهم مصداقاً للعقيدة الربانيّة الحقيقية ، التي لم تخضع يوماً لظالم ، ومرّت إلينا بعد تضحياتهم الجسام التي كلفتهم حياتهم شهداء من أجل دين الله تعالى بالسيف أو بالسمّ ، ومعاناتهم عبر الزمن ، حتى اوصلوا التوحيد الخالص الذي ينبني على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص ، وإثبات كلّ كمال فيه جلّ شأنه ، وتوحيده في الذات والصفات والخلق والرزق والحاكمية والعبادة ، إلهاً واحداً أحداً لا مثيل له ولا شبيه ولا ندّ ، ليس كمثله شي وهو السميع البصير لعلمهم بأنّ عدم بيانه ـالتوحيد الخالص ـ لا يؤسّس لعقيدة سليمة
صوتهم يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها :
《 قال علي عليه السلام : أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ... 》
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
شبهة :<< بابا حوزة بائسة الحيض والنفاس < شنو> اخرجوا من باب الطهارة والحيض ويجب أن يكون الاعلم في كل ابواب المعرفة خصوصا العقدية >

#شبهة :
<< بابا حوزة بائسة الحيض والنفاس < شنو> اخرجوا من باب الطهارة والحيض ويجب أن يكون الاعلم في كل ابواب المعرفة خصوصا العقدية >
قلنا :
أن للمرجعية الدينية وظيفة عظمى وفق الموازيين تستنزف كثيراً من طاقاتها، وهي الحفاظ على #الحوزات_العلمية، والرعاية لها، وتنميتها، من أجل بقاء المعين الذي يمدّ التشيع بالعلماء العاملين، الذين يصلحون للمرجعية، والذين يقومون بالتبليغ الديني للعباد، ويرفعون منار الإسلام في البلاد. ولهذه الوظيفة أولويتها
<<لأهميتها، إذ لولاها لانطمست أعلام الدين وضاعت معالمه.>>
ثم ان [ دعوى] شمولية المعرفة لكل ابواب العلوم استحسان بعيدة عن ا لموازيين بل هي كلمات إنشائية كيف والاعتقاد ليس عمل وإنما جزم لا يتحقق -بالتقليد- كما هو واضح لمن عنده أدنى معرفة .
ثم اننا لانعلم هل جنابه الكريم هو القيم ببيان #دور_العلماء في #عصر_الغيبة والمبين لتبويب ابواب الاستنباط او هذا رأيه الخاص الذي اجهل فعلا تحسسه من مسائل الحيض والنفاس ؟؟
ان تتبع بسيط <<لمدار الأعلمية هو الفقه والأصول>> يعني أن المدار في الأعلمية لايتجزء كتاب الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس عن غيره من مسائل الاحكام الاخر
بل نقول أي امتياز لباب الخمس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن باب الحيض والطهارة بئساً لمثل هذا <الفكر الهرموني>
فهل: الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الجواهر والسيد محسن الحكيم وغيرهم من #كبار_علماء_الشيعة لا يوجد لهم بحوث في #التفسير ولا في #العقيدة ولا في #الفلسفة وغيرها من الأمور، وكل تراثهم مقتصرٌ على #الفقه_و_الأصول، فعلى حسب ميزانكم فهؤلاء ليسوا مجتهدين فضلاً عن كونهم من أعاظم علماء الشيعة مالكم كيف تحكمون .
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
شبهة :لاملازمة بين افتراض الطاعة وبين #العصمة ثم من قال ان الاعتقاد بالعصمة للائمة شرط في دخول الجنة ؟

#شبهة :
لاملازمة بين افتراض الطاعة وبين #العصمة ثم من قال ان الاعتقاد بالعصمة للائمة شرط في دخول الجنة ؟
قلنا : هناك فرق بين #الإمامة_والعصمة، فهما مفهومان لا واحد
فإنّ العصمة شرط من شروط الإمامة، وهناك تلازم بين الإمامة والعصمة، ولكن التلازم من طرف الإمامة لا من الطرفين، فالإمامة مستلزمة للعصمة لان الإمامة تعني الحجية، الإمام من يكون حجة على الناس في قوله وفعله وتقريره، الإمامة تعني الحجية، والحجية ملازمة للعصمة، لا يمكن أن يكون حجة على الناس في قوله وفعله وتقريره إلا إذا كان معصومًا، وإلا لو كان الخطأ يتطرق إليه في كلامه أو فعله لم يكن حجة مطلقة على الناس، فالإمامة تعني الحجية، والحجية تعني العصمة .
والتأمل في مفاد خطابات الائمة تشير لهذا التلازم واستحالة التفكيك في فهم واقع الامامة دون الاعتقاد بالعصمة انظر مارواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 1/269 بسند معتبر عن سدير قال لأبي عبد الله عليه السلام《 قلت: فما أنتم؟ قال: نحن خُزَّان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا، ونهى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الأرض.》
وعنه ( رحمه الله) بسنده عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: 《 ان الله طهَّرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء على خلقه، وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القران معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا》
وفي الزيارة الجامعة لاحظ [ أركاناً لتوحيده، وشهداء على خلقه، وأعلاماً لعباده، ومناراً في بلاده، وأدلّاء على صراطه، عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهّركم من الدنس]
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
شبهة : أيها المقلد الشيعي تأخذ دينك من مرجع واجب الطاعة عليك لكنه ليس معصوم .؟

#شبهة :
أيها المقلد الشيعي تأخذ دينك من مرجع واجب الطاعة عليك لكنه ليس معصوم .؟
قلنا : ان وجود الامام ( عج )لطف ضيّعه الناس
لكن الإمام تدارك هذا اللطف بلطفٍ أضعف منه [لابد منه] وهو نصبه للسفراء وعندما امتنع هذا اللطف بسبب #الغيبة_الكبرى تداركه عجل الله فرجه بلطف آخر أضعف من الأول [ الرجوع للفقهاء ]
و[ المدعي] أوّل ما بدأ كلامه بمغالطة مفادها أخذ الدين بفهم الفقهاء واجتهادهم بحلقة منفصلة وفي قبال ماورد عن #الائمة_المعصومين
ونحن نقول أننا أخذنا ديننا من معصومين لمدّة تزيد على ثلاثمائة عام فإن في المدّة الممتدة قرابة ثلاثمائة عام ثبتت وترسخت مفاهيم الدين الكلية والمتوسطة بل ومعظم الجزئيات عن طريق الأئمة (عليهم السلام) لكثرة ما كرروها وأكدوا عليها بالنص المعصوم منهم وبالتالي اتضحت معالم الادلة للفقهاء
ومنه يفهم التعبير عن [ الفقهاء] برواة الحديث لان #علماء_الشيعة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة (عليهم السّلام) فإنهم لا يستندون إلى القياس والاستحسان والاستقراء الناقص وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون ، وإنما يفتون بالروايات المأثورة عنهم (عليهم السّلام) فهم في الحقيقة ليسوا إلاّ رواة حديثهم فصار الرجوع اليهم لايتعدى فهمهم لتلكم الكليات التي رسمها أهل العصمة وليس لهم الحاكمية في الإفتاء بالاستقلال عن الخطوط العامة التي رسخها الائمة عليهم السلام فدقق وتأمل .
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
الـفـصـل الثاني : الـسـيـد الـحـيـدري .. و مـصـادره الـعِـلّـمَـانِـيَّـة !!!
بسم الله الرحمن الرحيم , و الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبينا محمد , و على آلهِ الطيبين الطاهرين .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته , أخوتي و أخواتي في الله .
::: عــنـــــوان الــفــصـــــل الــثــانــي :
(الضعف العلمي و الفني لدى الكاتبة العلمانية آمال قرامي في وضع و تنظيم كتابها)
@ الباب الثالث : الخلط بين أسماء الكُتّاب و عناوين كتبهم :
ـــ أولاً : نجد أن الكاتبة آمال قرامي تُكرر ذكر كتاب (مَن لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق (رحمه الله) , و هو الكتاب الذي يلي في رتبتهِ كتاب الكافي في الحديث .
ففي ص948 تذكر : أبن بابويه (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمّي) , ((مَن لا يحضره الفقيه)) , بيروت , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , 1986 .
و في ص956 تذكر : القمّي (أبو جعفر محمد بن علي) , ((مَن لا يحضره الفقيه)) , بيروت , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , 1986 .
و هذا الخلل الفادح العلمي و الفني الذي صدرَ من الكاتبة يجعلنا أمام أحتمالين :
# ألأحتمال الأول : أن الكاتبة قد تنسبَتْ نفس الكتاب لمؤلِّـفَـيّن أثنين , و القرينة في ذلكَ , هو أن أحدهما ذكرته في حرف (الباء) من الفهرس , و الثاني ذكرته في حرف (القاف) من الفهرس .
# ألأحتمال الثاني : أن الكاتبة لم تنسب الكتاب لمؤلِّـفَـيّن أثنين , بل لمؤلف واحد ــ و هذا ما نُرجحه ــ و هو (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي) , و هو من أعلام القرن الرابع الهجري , المتوفى سنة 381هـ . و بالرغم من ذلك فإننا نجدها قد ذكرتْ الكتاب مرتين في الفهرس ! .
و على ضوء هذا ألأحتمال ــ الثاني ــ فإن إدراجه في الفهرس يجب أن يكون في حرف (الباء) و ليس في حرف (القاف) , لأنه عُـرف بـ(أبن بابويه) الذي هو لقبه , و أمّا تسميته بـ(القمّي) فهو ليس لقبه بل هو نسبته إلى مدينة قم . فلاحظ و تأمل .
و على كلا الأحتمالين فهو خلل علميٌ فادحٌ , لا يُغتفر عليهِ مع لحاظ أهمية الرسالة و رتبتها العلمية , و هي (رسالة دكتوراه) !! .
ـــ ثانياً : نجد الكاتبة مرة ثانية تذكر للكتابين الأثنين مؤلفاً واحداً في ص951 من الفهرس , رغم ما بينهما من بعد شقة ، فإن كتاب (الرحلة المغربية) لمؤلفهِ : أبو عبد الله الحاحي , هو محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود المشهور بالعبدري , فقد نسبتْ الكاتبة آمال قرامي هذا الكتاب إلى أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المشهور بأبن الحاج صاحب كتاب (المدخل إلى الشرع الشريف) , و يعود خطئها هذا في نسبتها كتاب العبدري الأول للعبدري الثاني لسَـبَـبَـيّـنِ :
# السبب الأول : جهلها بمؤلفي المصادر التي أعتمدتْ عليها في رسالتها الدكتوراه , و عدم التحقيق و التدقيق فيها و بمؤلفيها .
# السبب الثاني : عدم قدرتها على التفريق و التمييز بين مؤلِّـفَـيّن بسبب التشابه في لقبهما و هو (الـعَـبْـدَري) , الذي يشتركان فيه صاحب كتاب (الرحلة المغربية) و صاحب كتاب (المدخل إلى الشرع الشريف) .
فقد ذكر الشيخ محمد الفاسي محقق كتاب (الرحلة المغربية) في مقدمته التي لم تقرأها آمال قرامي : (( و من الأوهام المتعلقة بالعبدري أيضاً أن بروكلمان و مَن تابعه يُكنيه أبا محمد , و الواقع أن كنيته أبو عبد الله و أسمه محمد ، كما ورد في غالب النسخ المخطوطة الموجودة من رحلته , و كما يُكنيه مَن يذكره من المؤرخين و غيرهم , و يرجع هذا الغلط لكونه يلتبس كذلك بأبن الحاج العبدري الفاسي صاحب المدخل و كنيته أبو محمد ))[1] .
و أيضاً أشارة - أ . د . سعد بوفَلاقَة محقق كتاب (الرحلة المغربية) في مقدمتهِ و التي أيضاً لم تقرأها آمال قرامي , إلى الأشتباه الذي يصدر من البعض بسبب تشابه اللقب (الـعَـبْـدَري)[2] .
كما أن المؤرخ الثبت حسين مؤنس تحدث في هذا الموضوع مفصَّلاً بخصوص الأشتباه الذي يصدر من البعض في العبادرة الثلاثة[3] .
و بَـيِّـن و واضح أن الفرز بين المؤلفين و الدقة في نسبة المؤلفات لأصحابها يكون من خلال ضبط المعلومات و وضعها في إطارها ، فأبن الحاج قاضٍ و فقيه[4] , و من ثم فإن تناوله للقضايا الحضارية و أستشهاده بالبعض منها أو إبداء الرأي فيها سيركن فيه إلى الآليات و الأدوات الفقهية في التعليل و الترجيح و الحكم , أمّا العبدري الرحالة[5] فلن يتجاوز الوصف و النقل و الرواية , و ذلك لأن لكل منهما أدواته الخاصة بهِ في البحث , بحسب أختصاص كل منهما .
ـــ ثالثاً : و مرّة ثالثة تذكر الكاتبة آمال قرامي كتابين لمؤلِّـفَـيّن أثنين , رغم أن مؤلفهما هو واحد و ليس أثنين ! , ففي ص954 ذكرت كتاب (سراج الملوك) و نسبته إلى (محمد بن الوليد) , و ذكرت بعده كتاب (الحوادث و البدع) و نسبته إلى (أبي بكر) , و الصحيح أن الكتابين هما لمؤلف واحد , و أسمه الكامل هو (محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي , أبو بكر الطرطوشي)[6] ، و قد أشتبهتْ بين أسمه و هو (محمد بن الوليد) و بين كنيتهِ و هو (أبو بكر) , فتصورتهما أنهما شخصين ! , فلو قرأت آمال قرامي مقدمات المحققين للكتابين في عدة طبعات , أو تأملتْ مليَّاً في غلاف طبعة دار أبن الجوزي لكتاب (الحوادث و البدع) تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد المجيد , و غلاف طبعة دار المصدَّية اللبنانية لكتاب (سراج الملوك) تحقيق الدكتور شوقي ضَيف , لـَمَا أوقعتْ نفسها في هذا الخلط الشنيع الذي لا يُغتفر لها و لا لأمثالها !! .
ـــ رابعاً : و مرّة رابعة نجد آمال قرامي تنسب كتاباً لغير صاحبه ! , ففي ص952 تذكر كتاب (مفاتيح الغيب) المعروف بـ(التفسير الكبير) الذي ألفه الإمام فخر الدين محمد الرازي أبن العلامة ضياء الدين عمر , المتوفى سنة 604 , فتنسبه إلى عالم آخر من الـرَّيّ , و هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي , المتوفى سنة 311هـ ، أخي القارئ الكريم أضع بين يديك الفوارق بين الرجلين , لتتأمل بها :
الفرق الأول : التباعد الفكري و المنهجي بين الرجلين للمطلع على نهج كل منهما .
الفرق الثاني : الفرق الواضح بين أسميهما كما ذكرنا لكل منهما أعلاه .
الفرق الثالث : الفرق الكبير بينهما من حيث تأريخ وفاتهما , و هو قرابة الثلاثة قرون .
فمع وجود كل هذه الفوارق الواضحة الجلية , فإن آمال قرامي لم تتفطن إلى أنها بهذا الخطأ تعطي مؤشراً واضحاً على جهلها بأبي بكر الرازي , و هو أحد أهمّ مفكري الإسلام و عباقرته , و أكثرهم إنتاجاً في ميادين الطب و الفلسفة و الكيمياء .
فالذي يخلط بين الرازيَيّن (فخر الدين الرازي) و (أبي بكر الرازي) فهل يُمكن أن نثق بهِ في غيرهما ؟!!! .
ـــ خامساً : و مرّة خامسة تنسب آمال قرامي كتاباً لرجل آخر لتشابه في الأسماء , ففي ص948 نسبتْ لأبن بسام صاحب كتاب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) , و فاتها أن المُؤلـِّفين مُختلفان , فصاحب الذخيرة متوفى سنة 542هـ , و صاحب النهاية عاش في القرن الثامن للهجرة , و لأن آمال قرامي لا تقرأ من المصادر التي تدعي أعتمادها عليها , إلا بعض النتف من هنا و هناك , لم تتفطن لِمَا ورد في مقدمة الدكتور السيد الباز ألعريني لتحقيقه كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) للشيزري , و أعتقدت واهمة أنهما شخص واحد ، قال السيد الباز ألعريني : ( و أما كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لأبن بسام الذي عاش في القرن الثامن الهجري ــ الرابع عشر الميلادي ــ فيبدو كذلك أن معظمه منقول من كتاب الشيزري , إذ أنه فضلاً عن أتفاقه مع كتاب الشيزري في العنوان فإن مقدمتهما واحدة , و ذلك بأعتراف أبن بسام نفسه , بل يبدو أن أبن بسام أخذ تأليف الشيزري فنسبه إلى نفسه عنواناً و متناً )[7] , و لأن ناشر كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) لأبن بسام أكتفى بإيراد النص دون تحقيق أو دراسة أو تقديم أو تعريف بصاحبه , فقد توهَّمت آمال قرامي أن كل أبيض شحمة , و كل أسود فحمة , فخلـَّطتْ بينهما , لجهلها الفاضح !! . فلاحظ و تأمل .
@ الباب الرابع : إغفال ذكر المحققين .
رغم أن آمال قرامي أعتمدت عدداً كبيراً من النصوص المحققة إلا أنها تعمّدت عدم ذكر المحققين , و هو أمر لافت للنظر , لأن الباحث بتفضيله الأستناد إلى تحقيق على تحقيق آخر يكشف على قدرته في تمييز الطبعة الأحسن و الأجود , و من ذلك أعتماد آمال على الطبعة الشعبية للقوانين الفقهية لأبن جزي , بالرغم من وجود طبعة أفضل منها تونسية صدرت سنة 1926م , صحّحها و كتب مقدمتها الشيخ معاوية التميمي ! , أو أعتمادها نصوصاً جُمعت دون تحقيق نشرتها دار الجمل , التي حرصت فقط على التأكيد على ذكر مصمِّم الغلاف لأنه رَسَمَ صورة أمرأة عارية ! , أو تغييبها ذكر الأستاذين جليل العطية , و جمال جمعة , اللذين أستندت إليهما عشرات المرات في تحقيقهما لكتب الأصفهاني و التيفاشي و النفزاوي و التجاني , و الأمثلة كثيرة تندّ عن الحصر في هذا التخبط و التخليط في عدم أختيار النصوص المحققة الأفضل , يظهر كذلك في أعتماد الترجمة الأسوأ مع وجود الجيِّدة ! , من ذلك إهمالها ترجمة فؤاد زكريا لجمهورية أفلاطون و أعتمادها ترجمة حنا خباز ! . فلاحظ و تأمل .
:::
بعد صدور هذا الكتاب فقد نشرَتْ بعض المجلات أحاديث مع آمال قرامي أشادت فيه بمؤلفها المذكور , باعتباره فتحاً في الدراسات الإنسانية , و إضافة للأطاريح الجامعية المنشورة ، رغم أننا نعلم علم اليقين أن البعض إن أشادوا بكتابٍ أو قدَّموه فإنهم يفعلون ذلك من باب المجاملة , أو الغفلة عما فيه من الضعف و الركاكة , كما حدثَ هذا مع السيد الحيدري حفظه الله , لأن حياتنا الثقافية و للأسف الشديد تفتقر إلى القراءة النقدية الجادة , كما يفتقر مثقفونا إلى سعة الصدر و القدرة على قبول الرأي المخالف , إذ تلتبس الفكرة بقائلها لتصبح بذلك معالجتها تجريحاً , و تقويمها شتماً , و تصحيحها قدحاً في قيمة أصحابها و المواقع التي يحتلونها !! , و لكن و إن أعتبر أو يعتبر البعض من أننا نحاول الكيل أو التسقيط ــ و العياذ بالله ــ بالسيد الحيدري حفظه الله إلا أننا سوف نُكمل ــ إن شاء الله ــ باقي الفصول من التحقيق , لبيان ما غَـفَل عنه كل مَن أشادَ و مدحَ مُتفاخراً بهذا الكتاب و صاحبته , و أعتبر ــ جهلاً أو غفلةً ــ أن هذا الكتاب هو أفضل ما كُتبَ في هكذا موضوع .
( ( ( ( ( الـفـصـل الـثـالـث يـتـبـع ) ) ) ) )
الـهـوامـش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الرحلة المغربية , تحقيق محمد الفاسي : المقدمة ، ص ج .
[2] الرحلة المغربية , تحقيق - أ . د . سعد بوفَلاقَة : المقدمة ، ص9 .
[3] تأريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس : العبدري , ص518 .
[4] الموسوعة الفقهية , إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت , ملحق تراجم الفقهاء : ج3 , ص340 .
[5] الأعلام , خير الدين الزركلي : ج7 , ص32 .
[6] الأعلام , خير الدين الزركلي : ج7 , ص133 .
[7] نهاية الرتبة للشيزري : ص ح ، في دراسة للدكتور محمد جاسم الحديثي عنوانها (الحسبة و كتب التراث المؤلفة فيها) , منشورة ضمن كتاب جماعي (من تاريخ العلوم عند العرب) صادر عن بيت الحكمة ببغداد سنة 1998م ، قال : إن نهاية أبن بسام حققه حسام الدين السامرائي , و طبع في مطبعة المعارف ببغداد سنة 1968م , إلا أننا لم نتمكن من الإطلاع عليه .
طالب علم
المصدر:
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
الـفـصـل الأول : الـسـيـد الـحـيـدري .. و مـصـادره الـعِـلّـمَـانِـيَّـة !!!
بسم الله الرحمن الرحيم , و الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبينا محمد , و على آلهِ الطيبين الطاهرين .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته , أخوتي و أخواتي في الله .
صدر عن دار المدار الإسلامي في سنة 2007م كتاب (الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية) لمؤلفتهِ آمال قرامي , في حوالي الألف صفحة ، و هو عبارة عن أطروحة دكتوراه الدولة , أعدّت في كلية آداب منوبة تحت إشراف عبد المجيد الشرفي و هو يُشيد بها و بكتابها[1] , و لكن العجيب كُل العَجَب في الأمر هو أننا نرى السيد كمال الحيدري في أحدى دروسهِ يُشيد بهذا الكتاب و بمؤلفتهِ , و أثناء أسترسالهِ في الكلام عن المرأة و أحكامها في الإسلام , يقول : (( ... أكو كتاب مولانا شهادة دكتوراه آمال قرامي ... , أسم الكتاب الأختلاف , يقع في حدود ألف صفحة مولانا , من خيرة ما كُتِبَ في هذا المجال , أثبَتتْ هذه المرأة آمال قرامي و هي من مدرسة تونس المغربية هناك ... إلخ ))[2] , و يستشهد الحيدري و هو مُتفاخراً بهذه الكاتبة و بأطروحاتها ــ و هي علمانية المذهب ــ , و يعتمد على هذا الكتاب بأطروحاتهِ التي تُخالف أحكام القرآن الكريم في بعض أحكام المرأة !! .
و سوف ننشر بياناً توضيحياً و ننشره على شكل فصولاً متتالية , واحداً تلو الأخر , و نذكر في بداية هذه الفصول نبذة مختصرة عن هذا الكتاب , و نُبين فيهِ مواطن الخلل من الناحية العلمية و الفنية , كما هو المتعارف عنه في الجامعات العلمية في مناقشة رسالة الدكتوراه , ليتضح للقارئ الكريم مدى تخبط و ضُعف الكاتبة من الناحية العلمية و الفنية التي يعتمد عليها السيد الحيدري في بعض أطروحاتها , و بعد ذلكَ سوف نُبين من نفس الكتاب فساد أفكار و عقيدة هذه الكاتبة و نناقشها , حتى يطلع القارئ الكريم على بعض المصادر التي يعتمد عليها السيد كمال الحيدري في أستنباطاتهِ الفقهية .
و أترك الحكم لكم أخوتي و أخواتي الكرام , و كلي أمل على أن يُبدو رأيهم الأساتذة الجامعيون الكرام , الذين قد حظيتُ بشرف صداقتهم في الفيسبك .
::: عــنـــــوان الــفــصـــــل الأول :
( الضعف العلمي و الفني لدى الكاتبة العلمانية آمال قرامي في وضع و تنظيم كتابها )
@ الباب الأول : الخلل و التلبس في عنوان الكتاب , و يطرح عدداً من التساؤلات :
ـــ أولاً : لماذا استعملت الكاتبة لفظ الأختلاف بإطلاقهِ , و دون تحديد لمجالاته أو مضامينه أو مظاهره ، فهل قصدها الأختلاف بين المذكر و المؤنث , أو الذكر و الأنثى , أو بين القراءات , أو بين المدارس الفقهية , أو بين الفرق الإسلامية , أو بين المذاهب الصوفية .....؟ , ذلك أن الأطاريح الجامعية الجادّة تلتزم حدوداً معينة لا تخرج عنها , فكلما كان الموضوع ضيّقاً كلما أستطاع الباحث الإلمام بأطرافه , و الإحاطة بمصادره , و من ثم تتأتى الجدّة في الدرس و القدرة على الإضافة , و العكس صحيح , إذ كلما كان الموضوع منفلتاً من أيّ عقال كلما كانت المعالجة سطحيّة و عبثيّة لا غناء فيها .
ـــ ثانياً : لماذا لم تُحدّد الكاتبة الفترة الزمنية المدروسة , و الحال أن كلّ الأطاريح الجامعية تلتزم بفترات زمنية مضبوطة , لا تتجاوز بأيّ حال من الأحوال مائة سنة , و غالباً ما تكون أقلّ من ذلك بكثير , حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج أدق وأعمق بدراسة الجزئيات و التفاصيل , و وضعها ضمن سياقها التاريخي ، أمّا الإصرار على تعويم الزمن و فتح السنوات و القرون على بعضها البعض لمدّة تفوق 15 قرناً كما هو الحال في أطروحة آمال قرامي فلن يؤدي إلا إلى التلخيص و الاقتباس و التعميم , و هو ما سنفصِّل فيه القول لاحقاً .
ـــ ثالثاً : لماذا لم تُحدّد آمال قرامي مجالاً جغرافياً مُعَـيَّـنا لدراستها , كأن يكون مدينة أو بلداً , أو منطقة ما ، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن الثقافة و مظاهرها تختلف من بيئة إلى أخرى , حتى و إن أستندت إلى أصل عقدي واحد , فعادات الزواج في وسط إفريقيا هي غيرها في الشمال , و التربية الناشئة في الحضر هي غيرها في البادية , و المعاملات المالية في الموانئ هي غيرها في المناطق الداخلية , و هكذا .
و لا يخفى أن هَمّ الطالب عند وضع عنوان لبحثه هو الدقة , و الوضوح , و الضبط , ممّا يُؤشر على عقلية نقدية , قادرة على التمحيص و الفرز بين ما هو من صلب الموضوع فتأخذ به , و بين ما هو من أطرافه و حواشيه فتدعه , أو تتناوله بمقدار ما يخدم موضوع الدراسة ، أما العناوين التي تحتمل الزيادة و النقصان فلا تدلّ إلا على اللهاث وراء السهولة و السعي إلى إثارة عموم القراء بما هو هذيان و هذر .
و نورد ــ على سبيل المثال ــ جملة من عناوين الأطاريح الجامعية الجادّة التي أعِدَّ بعضها منذ منتصف القرن الماضي دون ترتيب معيَّن حتى يتبيَّن للقارئ الفرق بين عنوان يحمل دلالة علميّة زاخر بالإيحاءات و الضوابط , وآخر لا لون و لا رائحة و لا طعم له :
1 - (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري) , للدكتور عبد العزيز الدوري .
2 - (التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن الأوّل الهجري) , للدكتور صالح أحمد العلي ، علماً بأن الدكتور هشام جعيط , تناول نفس الموضوع و لكن في الكوفة .
3 - (الحركة الطالبية التونسية ، 1927ـ 1939) , للدكتور محمد ضيف الله .
:::
@ الباب الثاني : الخلل في مصادر الكتاب و تنظيمها .
من المعلوم أن أي دراسة علمية جادّة تستند إلى جملة من المصادر و المراجع التي ينتقيها الباحث وفق مقاييس علميّة متعارف عليها , و من ثم يُمَهِّد لدراسته بمقدمة يَعْرض فيها تقييمه و مبرِّراته في أختياره مصادر مُعـيَّـنة دون غيرها , و ذلك بعد ترتيبها زمنياً , و أنتقاء أفضل الطبعات و أدقها وأكثرها أرتباطاً بموضوعه .
ففي مقدمة كتابها لم تتناول آمال قرامي أي مصدر من مصادرها بالتعيير أو التقويم , بل أكتفت بإعادة صياغة بعض الأفكار التي لم تمَلَّ إعادتها و تكرارها عشرات المرّات , فانحرفت بالمقدمة عن دورها , وحَرَمَتنا من أكتشاف قدراتها النقدية , و مدى توفقها في أختيار الأدقّ و الأصوب و الأصحّ , ممّا هو متوفر بين يديها ، و المتأمل في القائمة التي أعدتها آمال قرامي يكتشف بوضوح أنها أكتفت بجمع كل ما هبّ و دبّ , من قريب أو من بعيد , و حشرت الكلّ دون فرز أو ضبط , و دليلنا على ذلك ما يلي :
1 - جرت العادة من الناحية العلمية و الـفـنـيـة أن تُوضع الكتب المقدّسة و المعاجم و الموسوعات لوحدها , إلا أن آمال خصَّت الكتب المقدسة بتعامل لم نشهد له مثيلاً فيما أطلعنا عليه من فهارس كتابها , فـبدل أن تضع في رأس القائمة لخصوصيّة التعامل معها أدرجتها ضمن المُسرد الذي نشرته ، ففي ص955 وضعتْ القرآن الكريم ضمن المصادر فيما بين أبن قُدامة و ثابت بن قرة , و وضعت بين قوسين هلالين رواية حفص بن سليمان ، و هو أمر عجيب ! , فالقراءات لا علاقة لها بالمعاني الواردة بين دفتي المصحف , لأنها لا تتناول إلا كيفية نطق بعض الألفاظ , و لا تحمل أيَّ تغيير في مضامينها ، و كأني بها تشير إلى أن القرآن ليس قرآناً واحداً بل هو متعدّد و أختارت منه ما ذكرت بين قوسين ! ، و في ص956 وضعتْ الكتاب المقدس فيما بين الكاساني و أبن كثير ، و هذا الأسلوب الملتوي في التعامل مع الكتب المقدسة مقصود للقدح في صحّة نسبتها إلى الله , و هو أسلوب لم تستعمله مع غيرها , و دليلنا على ذلك أنها جمعت الموسوعات , و وضعتها في ذيل فهرسها في ص979 .
2 - في ص960 ذكرتْ آمال قرامي أنها أستندت في بعض ما ذهبت إليه إلى كتاب (الجنس في أعمال السيوطي) الذي أعدّه و نشره صاحب دار المعارف بسوسة ، و قد سبق و تناول الكاتب و الأستاذ أنس الشابي التونسي في كتابهِ (أهل التخليط) هذا الخليط العجيب من الأوراق التي رمى بها صاحبها في الأسواق , و لا مندوحة عن الإشارة إلى أن أعتماد آمال قرامي على هذا الكتاب المدلـَّس و المدلـِّس يُؤشر على جهل فاضح بأوليات البحث و أستهانة بالنصوص و بأصحابها , ذلك أن الكتاب المشار إليه لا يعدو أن يكون تجميعاً لأوراق لا رابط بينها سوى الجنس , محرّرة بأسلوب سوقي فضائحي صادم للحياء , نُسبت زوراً إلى الإمام جلال الدين السيوطي ، و غاب عن صاحب دار المعارف بسوسة , و تبعته في ذلك آمال قرامي , من أن نسبة أي نصٍّ لأيّ كاتب من الكتاب خصوصاً منهم الذين لهم قدم في سوق المعرفة و العلم يجب أن يستند إلى دراسة داخلية للنص من مختلف النواحي , كالأسلوب و المصادر المعتمدة , و المرحلة التاريخية التي كُتب فيها , و موقعه ضمن المسيرة الفكرية للرجل ...إلخ , فإن أهملنا ما صنع صاحب دار المعارف بسوسة لجهالته , و فرحه بانقطاعه عن التعليم منذ المرحلة الابتدائية , فكيف يستقيم الأمر و نحن إزاء أطروحة دكتوراه أشرف عليها و أجازها أساتذة , و صَرفت عليها الدولة آلاف الدنانير ؟! .[3]
:::
مـلاحـظـــــة : أرجوا من أحبتي الأفاضل , الفاضلات , على أن يستمعوا إلى درس السيد كمال الحيدري المنشور في أول تعليق بعد قرآءة المنشور , لتكتمل الصورة فِيما طرحناه و ما سوف نطرحه . و أيضاً نرجوا من الأخوة الأحبة الذين لا يروق لهم هذا المنشور فإن أرادوا أن يُعلقوا نأمل أن يكون تعليقهم بمستوى أخلاقهم , لأننا بحمد الله تعالى لم نتجاوز حدود الأدب و لو بكلمة واحدة , و إنما نُحاول بقدر الإمكان أن يكون طرحنا علمياً .
( ( ( ( ( الـفـصـل الـثـانـي يـتـبـع ) ) ) ) )
الـهـوامـش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع مقدمة كتاب (الأختلاف) لآمال قرامي .
[2] بحوث في طهارة الإنسان , السيد كمال الحيدري , درس / 21 .
[3] للتفصيل راجع كتاب (أهل التخليط) للأستاذ أنس الشابي التونسي .
طالب علم
المصدر:
http://www.kitabat.info/subject.php?id=88154
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
أساليب السيد الحيدري الخطابية ( 1 )

(أوّلاً): إنّ المنهج اللائق بمقام البحث العلميّ –وخصوصاً في الحوزات العلميّة حيث اتّصاف أهلها بالمبادئ الإيمانيّة- منهج موضوعيّ يبتني على الدقّة والإنصاف والعمق والمتانة والنضج.. وهذا بخلاف ما يجده الناظر في أسلوب المتحدّث في المقطع المُرفق؛ فهو يعتمد أساليب خطابيّة وغير علميّة ومن ذلك:
(1) الاستعانة بدعوى الجِدة في الطرح لتوثيق رأيه وترويجه وتوجيه الناس إليه ووصف الآخرين بالتخلّف و«التكلّس»، مع أنّ مجرّد جدة البحث لا دخالة لها في قوّته، كما أنّ قدمه وسبق طرحه لا يكون حجّة على ضعفه.. وإنّما ذلك استغلال للعناصر الشكليّة الفاعلة في نفس الإنسان والمثيرة لنزوعه الفطريّ نحو كلّ ما هو جديد؛ نتيجة اعتياده وملله ممّا تكرّر عليه.
(2) إنّ الدراسات العليا (الخارج) –والتي تشبه الدراسات الجامعيّة- بحوث تخصّصيّة تبتني في منهجها ومحتواها على أدوات فنيّة خاصّة؛ ولذا فهي ليست ممّا تصلح للنشر العامّ وجعل الجمهور حكماً في البتّ فيها.. إلاّ أن يكون الهدف: محاولة إيهامهم بامتلاك القدرة الفكريّة والقابليّة العلميّة.
(ثانياً): إنّ فكرة (الحُجّة) –والتي جعلها من مبانيه الفكريّة- سبق طرحها في كتب علم الكلام والأصول -وإن لم يتمّ التركيز عليها في مقام التبليغ الدينيّ كما سيأتي توضيحه- وحاصلها على ما هو المشهور لدى العدليّة -ومنهم الإماميّة-:
أنّ القاصر -الذي استفرغ وسعه لأجل الوصول إلى الحقيقة، وانتهج سننها الموضوعيّة- لن ترتهن في ذمّته المؤاخذة على فرض عدم إصابته الحقّ؛ فإنّ من أراد الحقّ ثمّ أخطأه ولم يُوفّق لنيله ليس على حد من أراد الباطل فأصابه.
وهذا المعنى في أصله ممّا لا شكّ فيه.. لكن يُلاحظ عليه:
(1) إنّ من الخطأ -على ما يظهر بملاحظة النصوص الدينيّة- التسوية بين المصيب والمخطئ على أساس استوائهما في الجهد؛ فإنّ من أخطأ الحقّ لن يظفر على كلّ حال بالنماءات المعنويّة والآثار الفاضلة المترتّبة على فعل من يصيب الحقّ ويعمل به، سواء كان فعله للحقّ عن تلقين أو عن بحث -نعم، البحث العلميّ يوجب أن يصير الإنسان في الغالب أبصر بعمله وأيقن بمعتقده، ولكنّ هذا بحث آخر-..
ويمكن التنظير لتقريب ذلك بـ: شخصين، يعتمد «أحدهما» بحكم بيئته والأطعمة المتوفّرة في محيطه على نظام غذائي يعود بالنفع على صحّته ويطيل في عمره، ويعتمد «الآخر» بحكم بيئته أيضاً على نظام غذائي يشتمل على أطعمة أقلّ فائدة.. وفي هذه الحالة: فإنّ الشخص الأوّل سوف يكون عمره أكثر وصحّته أقوم من الشخص الآخر الذي اعتمد نظاماً غير صحيّ، سواء علم ذلك الشخص الأوّل أنّ هذه النظام الغذائي هو النظام الصحيح والأسلم أو لا.
(2) إنّ التبليغ الدينيّ مشروع ينطوي على بعد تربويّ يتجاوز بعده العلميّ؛ فلابدّ من رعاية ضوابط التربية ومقتضياتها.. ومن ذلك: أنّ من غير الصحيح في مقام التربية والتزكية التركيز على معذّريّة الحجّة؛ حتّى لا يصير ذلك مبرّراً لعدم المواصلة في طلب الحقيقة والسعي خلفها؛ وذلك أنّ كلّ صاحب ضلالة يتمسّك حينئذ بشبهات يراها أدلّة على الحقّ.. بل لابدّ من التركيز على أنّ الله تعالى لم يطلب من عباده الإذعان بشيء إلاّ وضمّنه الحجّة الكافية عليه، بل تعهّد أن تكون له الحجّة البالغة فيه..
وهذا المعنى ممّا يظهر -بشكل عامّ- بالنظر إلى النصوص الدينيّة في القرآن الكريم والسنّة -ولربما يُستفاد من جملة من الروايات الشديدة الواردة في باب المستضعف في الكتب الروائيّة-؛ حيث يُلاحظ أنّ أدبيّات التعبير فيها على نحو لا يؤمّن من لم يبلغ الحقيقة عن احتمال التقصير.
(ثالثاً): وأمّا ما ذكره:
[1] مِن عدم حجيّة فهم الآخر للنصوص الدينيّة.. فهو -فضلاً عن عدم العلاقة بينه وبين القول بقيمة الحجيّة على النحو الذي تبنّاه- ممّا تمّ التعرّض له في كتب الأصول في مبحث حجيّة الشهرة، وقد ذهب كثير من الأصولييّن إلى عدم حجيّتها، إلاّ أنّهم نبّهوا على أنّ اشتهار فهم بين العلماء –وهم من أهل الاختصاص- يزيد من احتماليّة استنادهم إلى مدرك معتبر؛ ومن ثمّ يقتضي ذلك مزيد فحص وتحوّط واستيعاب للنظر في الفروض المحتملة.. وهذه طريقة معهودة عند العقلاء عامّة؛ فإنّ الطبيب –مثلاً- يدقّق في تشخيص المرض أكثر فيما إذا خالفه كثير من الأطبّاء المرموقين في الرأي.
وأمّا الضرورة فإنّ الأمر فيها أعقد بكثير؛ لأن احتمال تحوّل مطلب معيّن إلى حقيقة بديهيّة في مذهب أو دين يعتمد علماؤه التحقيق والتدقيق من دون أن يكون لهذا الأمر مستند.. هذا الاحتمال ضعيف جدّاً.
[2] ومن أنّ المنهج السائد في الحوزات العلميّة مبنيّ على كون آراء العلماء مقدّسة.. فهو خطأ كبير، بل خطيئة كبيرة؛ إذ من الواضح لمن راجع أيّ كتاب استدلاليّ حجم المناقشة بين العلماء وردّ بعضهم على الآخر، ولربما يكون ذلك في كثير من الأحيان بلغة الحزم والشدّة؛ لتحفيز عموم الطلبة على مناقشة الأفكار والتأمّل فيها وعدم الجمود عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=rwzXQpsfFzc
طالب علم
المصدر:
http://www.kitabat.info/subject.php?id=87735
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
اجتهادات السيد كمال الحيدري في الميزان
يَعتبِر السيد كمال أنه يتميّز في مبانيه الأصولية بأمرين :
الأول :
إن الاستظهار من النصوص الشرعية في كل زمان حجة ! ولا يجب علينا الالتزام بالظهور في عصر النص .
بمعنى : أنك لو فهمت من نصٍ شرعي معنى ما بحسب التفاهم العرفي اليوم ، فإن فهمك هذا حجة وإن كان مخالفاً للتفاهم العرفي في زمن المعصوم (ع) !
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية)

#مقالات_الشيخ_محمد_التميمي
#الاجوبة_العلمية_للشيخ_محمد_التميمي
جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية) .
_._._._._._._._._
سماحة العلامة الشيخ محمد التميمي (حفظكم الله)
هل النظرية التي سنعرضها بالاسفل أمام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي أو مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية :
أن جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا" للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات !
وأن عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايجعلها توقيفية ؛ لان عمله (صلى الله عليه وآله) كان متناسبا" مع ظروف زمانه (صلى الله عليه وآله) ، ولو جاء (صلى الله عليه وآله) بزمان آخر وظروف اجتماعية أخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات أو ثلاث ؟ !
وعليه يمكن لفقهاء الغيبة الكبرى الاجتهاد بأخراج مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر ؟ .
♧▪▪▪▪♧
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، وبعد :
للجواب على هذا السؤال المهم والخطير نقول :
حسب نظري القاصر أن أحكام العبادات كلها توقيفية تعبدية وإخراجها من دائرة الثوابت والتعبديات الى دائرة المتغيرات والاجتهادات محل إشكال بل منع .
نعم من الممكن القول :
أن بعض بل عديد من أحكام المعاملات فيها قابلية التبدل من العناوين الأولية الى العناوين الثانوية ؛ لأن هذه الأحكام _تختلف عن الأحكام العبادية _ وهي غير توقيفية ويستطيع الفقيه أن يقوم بتطبيق نظرية (الزمان والمكان) إذا كان من القائلين بها _ بعد طرح الأدلة على تماميتها _ أو الانتقال من فقه الأحكام الى فقه النظريات كما أفاد ذلك أستاذ أساتذتنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس الله سره) في كتابه القيم أقتصادنا ، أو بما عبر عنه ب(منطقة الفراغ التشريعي) .
وحيث ان الموارد التي ينبغي للفقيه الوقوف عندها ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات محددة ومنقحة عنده ، وهكذا الموارد التي يجوز للفقيه التحرك فيها وإعمال اجتهاده الفقهي ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات محددة كذلك فهو يعلم متى يقبل المورد الاجتهاد ومتى لا يقبل ذلك .
فالمفاهيم القرآنية توقيفية تعبدية ، والفقيه يمكنه القيام بعملية استنباط من هذه المفاهيم وفق منظور المفسر الحقيقي للقرآن الكريم وهم الرسول والائمة (عليهم الصلاة والسلام ) وهذا هو جزء من عمل الفقيه ووظيفته ، ولكن يأتي الفقيه ليستنبط حكما" مخالفا" لحكم المعصوم (عليه السلام) فهذا هو الممنوع والمرفوض ، والمفروض التمييز بين هذين الأمرين ؛ لوضوحهما عند من تحققت عنده الفقاهة .
وبعبارة أخرى :
أن الأحكام العبادية الكلية النوعية _ وليس التفاصيل من قبيل تحديد القبلة أو صلاة المسافر فأنها وقع الاجتهاد والخلاف فيها ولكن نقصد عدد الصلوات أو غيرها _ كلها داخلة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وهذا هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه ،
وقد قامت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك ، وهو يقع مصداقا" لمقولة (حلال محمد _صلى الله عليه وآله _ حلال ليوم القيامة وحرام محمد _ صلى الله عليه وآله _ حرام ليوم القيامة ) ومن يجتهد في ذلك فإن اجتهاده حرام ؛ لأنه بعرض الشريعة الإسلامية وهو الاجتهاد البدعي المحرم الاستعمال في الشريعة ، بينما أحكام المعاملات فإن بعضها يقع ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وبعضها _إن لم نقل العديد منها_ ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات .
وختاماً أقول :
من المجازفة بمكان دعوى تبدل العبادات وفق تغير الزمان والمكان واجتهادية مفاهيم القرآن .
والله العالم والهادي والعاصم .
الشيخ محمد التميمي / النجف الأشرف
٢٨_ ربيع الأول _ ١٤٣٨هجرية .
المصدر :
https://www.facebook.com/fdgct/
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
رد سماحة آية الله السيد علي الأكبر الحائري على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
هذه النظرية باطلة مائة بالمائة وقائلها منحرف.
الفقيه سماحة اية الله السيد علي الأكبر الحائري ( حفظه الله )
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
رد حجة الاسلام سماحة العلامة السيد محمد كريم الموسوي على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
بسمه تعالى
هذه النظرية مردودة حيث انها خالفت نصوص الروايات والعقائد الامامية ونلخص قولنا ببعض النقاط .
١- حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال الى يوم القيامة وحرام محمد(صلى الله عليه وآله) حرام الى يوم القيامة.
٢- قبل تشريع اي حكم تكليفي سماوي هناك مرحلة سابقة تسمى عالم الثبوت وهي تمر بمراحل ثلاث اساسها العلم وارادة المولى عز وجل والاعتبار وهذه تستدعي مخاض الحكم ان صح التعبير ثم عالم آخر هو عالم الاثبات ومن مجموعها العلم التام بكل مفردات الحكم وخلاصة هذا القول ان الحكم يحتاج بالضرورة الى علم بالواقع لا بالظاهر والعلم بالواقع لا يعلمه الا المولى عز وجل وهو الذي يأذن لرسوله وامتداده بالعلم به .
٣- هناك احكام كانت وقتية لحكمة ولمصلحة يجعلها المولى عز وجل وهذه تنسخ من حكم آخر وهي الناسخ والمنسوخ بشرط ان يكون من نفس المشرع والا وقعنا في محذور التفاضل بلحاظ المولى عز وجل والموجودات.
٤- اذا كان الفقيه في زمن الغيبة يشرع (لايستنبط) بحكم جديد فهذا يستدعي في أقل التقادير تساوي المشرعين في الاحكام بما فيهم المولى عز وجل (حاشا لله) .
٥-اذا قلتم ان هناك احكاما وجدت في زمن متأخر عن زمن الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) والائمة المعصومين (سلام الله عليهم) اقول هذه كشفت وبانت وفق مفاتيح المولى عز وجل اوجدها في كتبه وبانت على ألسن رسله وهذا ما بينه المولى عز وجل في كتابه المنزل ( فيه تبيان لكل شيء) فيه التصريح والتلميح والاشارة .
٦- في مذهب الامامية هذا الذي قلته وبعبارة ادق (لا اجتهاد مقابل نص)اما غيره فيقولون ان المجتهد عندما يغيب عنه الحكم الواقعي فانه يعمل وفق نظره لاستنباط -او قل تأسيس- حكم ظاهري وان خالف الحكم الواقعي فان الواقعي سيكون تبع لذلك الحكم المستخرج وان اخطأ الواقع فانهم يقول ان حكم الظاهر يصحح الموقف العبادي وان كان خطأ الحكم الظاهري لذا يطلق عليهم الصوبة .
٧-اذا لم تكن الاحكام الصادرة من المولى عز وجل توقيفية - ان صح التعبير- وان المجتهد يبرز حكما جديدا فكيف ان الاحكام باقية مثل حكم المسافر الذي يتجاوز المسافة الشرعية ٤٤كم فتسقط عنه بعض الاحكام والواجبات كما في وجوب الافطار وغيره في حين ان الانسان بظل العلم يسافر الى المشرق والمغرب دون جهد وتعب كما في المسافة الشرعية .
٨-لو تنزلا اقرينا بان الاحكام في هذه الفترة المشار اليها من قبل المجتهد او من اي موجود آخر بما فيهم الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) فهذا يستدعي بعدم صدق صفة خاتمية رسالة الاكرم (صلى الله عليه وآله) ويقال ايضا بنقصها .
حجة الاسلام سماحة العلامة السيد محمد كريم الموسوي ( حفظه الله)
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
رد الفقيه سماحة اية الله الشيخ هادي آل راضي ( حفظه الله )على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
هذه النظرية تنافي ثوابت الدين ، وتطبيقها يؤدي الى محقه ومحوه .
الفقيه سماحة اية الله الشيخ هادي آل راضي ( حفظه الله )
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
رد المرجع سماحة اية الله الشيخ محمد السند البحراني ( حفظه الله) على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب:
1- قد توهم فلاسفة الحداثة الغرب كالسفسطائيين القدامى وكنظرية التضاد الدياليكتك أن الدين كله متغير ولا ثابت في الدين ، مع ان هذه المعادلة التي يزعموها يبتغون فيها الثبات وعدم التغير فكروا على ما فروا منه ، مما ينبه على ان الثابت والثبات لا يمكن جحوده وانكاره من رأس وانه لابد في الحقيقة من ثبات وضرورة لا تغير ولا تخلف ولا تبدل فيها وبالتالي لا ظن ولا اجتهاد فيها ، وان المتغير لابد له من ثابت ضروري .
2- وهذا هو شأن الوحي والعقيدة ان المعلومة فيها شمولية ثابتة محيطة بالعوالم فضلا عن العالم الارضي .
3- ثم لا تلازم بين المتغير والاجتهاد الظني لان الاجتهاد الظني قد يتعلق بالثابت كالانسان القاصر الضعيف اداركا بالحقيقة الازلية الالهية والنبوة والامامة والمعاد، والعكس قد يتعلق اليقين بما هو متغير ولو بلحاظ ظرفه كعلم الله تعالى بالمتغيرات ، فهو خلط بين درجة الادراك و سنخ الشيءالمعلوم المدرك من جهة الثبات او التغير .
فإن هناك جملة من الامور فوق الزمان والمكان المتغير من عالم محيط آخر كما هو شأن الأصول في الدين .
المرجع سماحة آية الله الشيخ محمد السند البحراني ( حفظه الله)
أرسلت بواسطة admin في شنبه 24 / 12 / 1395
|
صفحه قبل 1 ...
5 6 7 8 9 ...
51 صفحه بعد
جميع الحقوق محفوظة لمدير الموقع ؛ أي نسخ المحتوي مسموح فقط مع ذكر المصدر.. تنوية كما ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎلات او بحوث ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺃﻱ صاحب الموقع ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ،، ...

 إحصائيات الموقع :
إحصائيات الموقع :






![]()